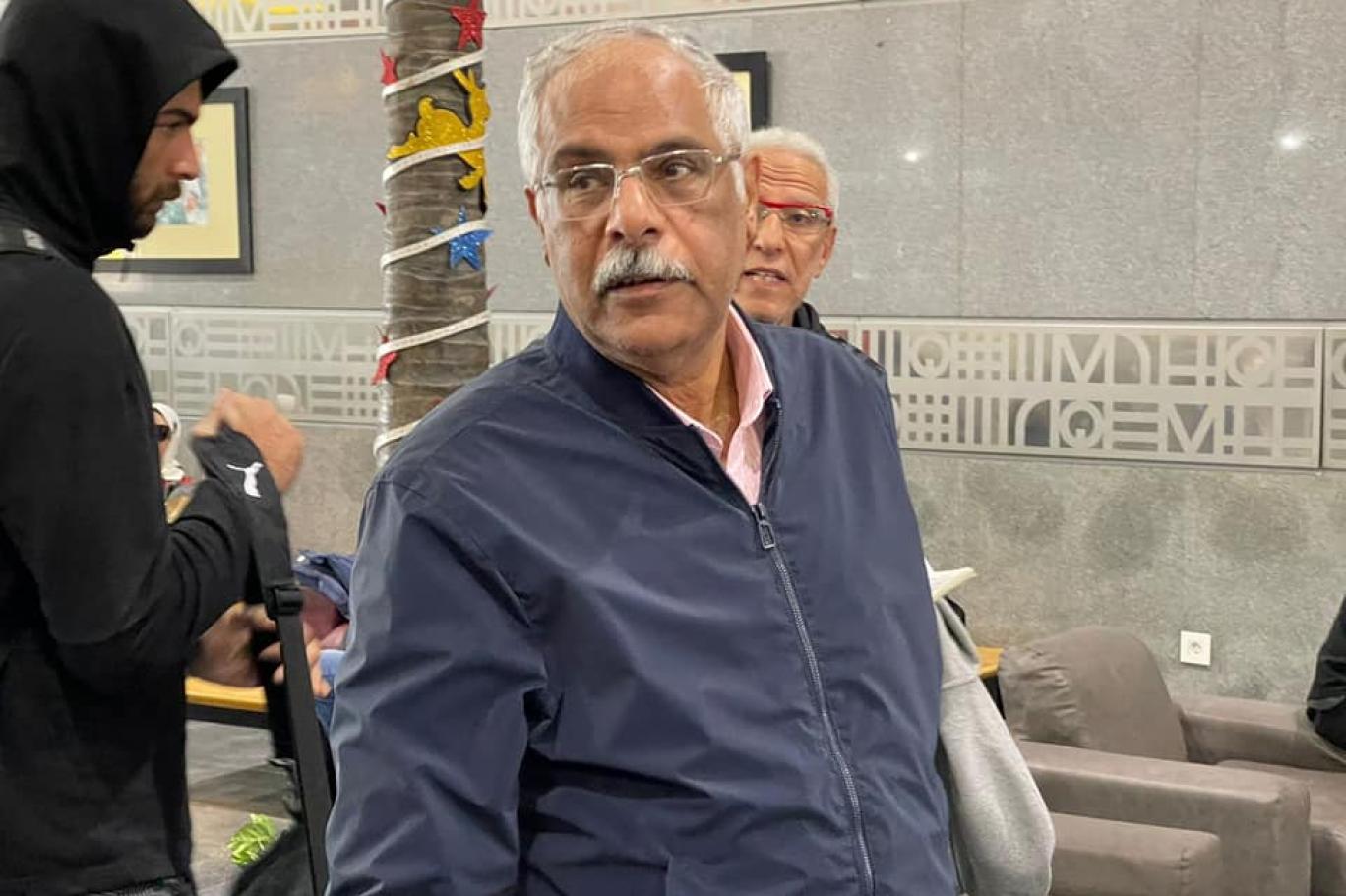كان ذلك في أواخر الزمن المبارك الذي كان يمكن فيه، بعد، للفن أن يلقى احتفالات كبيرة تمجده وتمجد ذكراه، وللمدن الفاضلة في التاريخ أن تستعاد كذكريات سعيدة. في زمن كانت باريس بخاصة قد انكبت فيه على الاحتفال بمدن أخرى وأزمنة أخرى لم يحزنها أن تعلن أنها تحتفل بها لكونها شاركتها بناء حداثات القرن العشرين. وكان الدور قد وقع عام 1986 تحديداً على فيينا التي خصها مركز جورج بومبيدو الثقافي وسط العاصمة الفرنسية بواحد من أضخم الاحتفالات التي كرمتها في تلك الأزمنة. ولئن كان ذلك الاحتفال قد بات منسياً اليوم إلى حد ما، فإن الجزء الأساس من ذكراه ما يزال حياً بين دفتي “كاتالوغ ضخم” لا يزال يعتبر حتى اليوم واحدة من أغنى الإطلالات على مفصل أساسي من مفاصل التاريخ الحضاري لتلك المدينة. ولعل من أهم ما لفت النظر حينها العنوان الذي حمله ذلك السفر الضخم والاستثنائي: “فيينا 1880-1938: الكابوس السعيد” وكان جديراً بالطبع بصورة فيينا: نهايات عصر، التي وضعتنا مباشرة في مواجهة تلك الحقبة… ولنقل: في مواجهة حلم الحداثة… أو في مواجهة طفولة القرن التالي.
نهايات أمور كثيرة
ففي فيينا، التي كانت تعيش كما يخبرنا المعرض والكاتالوغ، في مناخ النهايات (نهايات القرن ونهايات المدينة ونهايات العصر الذهبي) ولد كل ذلك الشيء الكبير الذي سيطلق عليه المؤرخون، فيما بعد، اسم الحداثة: والحداثة هنا هي هي الابتكار، بمعنى أنه من الصعب أن نقول إن ما كان يولد في رحم تلك المدينة آنذاك، كان يولد من تيارات أو مدارس أخرى في مجالاته الإبداعية، فالإبداع كما ولد في عاصمة الإمبراطورية النمساوية – الهنغارية، لم يكن نقطة ذروة، مثلاً، في مسيرة إبداعية؛غوستاف كليمت، وشيلي، وكوكوشكا والآخرون، لم يكونوا الاستمرار الطبيعي لتيارات فنية سبقتهم، حتى ولو كانوا الركيزة التي على أساسها قامت التيارات الفنية التي لحقتهم. وهذا الذي يمكن أن يقال عن الفن التشكيلي ينطبق كذلك على العمارة وعلى الأدب والشعر والفكر وحتى السينما ومجال التحليل النفسي.
المدينة أخذ وعطاء
في فيينا في ذلك العصر كان الجديد الأول يكمن في أن كل النتاجات الذهنية (من فكر وفن وأدب) إنما تولدت من فلسفة جديدة ونظرة إلى العالم مختلفة عن كل نظرة سابقة له. من هنا كان من الطبيعي أن يتحقق في حيز فيينا الثقافي ذلك الالتحام أو الاتحاد الذي حلم به الفلاسفة طويلاً منذ أرسطو، بين الفنون والآداب والعلوم وشتى ضروب الفكر والعمران.. تحقق الالتحام عبر نظرة جماعية إلى العالم، وفلسفة تنظر إلى الإنسان، مرة أخرى، في ارتباطه بالمدينة كمكان وبالانعطافة بين القرنين كزمان. ففي فيينا، كانت المدينة بشموخها وغموضها، بميتافيزيقيتها وعاديتها، بإنسانها اللاهي وإنسانها القلق، كانت هي العالم الصغير الذي شكل لفئة مميزة من البشر، مرجعية وربما مثلاً أعلى. وذلك الارتباط الحتمي للمنتوج الثقافي بالمدينة كان هو الذي أعطى لفيينا نهايات القرن التاسع عشر، ذلك الطابع الفريد. الطابع الذي التقت عنده الثنائيات: ثنائية الموت/ الحياة. ثنائية القلق/ السعادة. ثنائية الفن/ الإنسان. ثنائية النفس/ الصورة. كانت فيينا، انطلاقاً من كل ذلك، وفيه، تمارس بامتياز لعبة التبدل على الصعيد التاريخي. لعبة الانعطاف.
كمون الموت الغامض
إذا كانت مسرحيات هوفمنشتال، وروايات ستيفان تسفايغ، وقصص شنيتزلر، وابتكار فرويد للتحليل النفسي كوريث شرعي ومعاصر لعلم النفس الذي شرع بوضعه على الرف… وكتابات ورثة فرويد وحوارييه… إذا كانت كلها قد أمعنت في لحظة أو في أخرى في تعرية الإنسان -في فيينا وفي غيرها- من ثوب السعادة الوهمي الذي ارتداه في غفلة عن حقيقته، فإن اللوحات التي راح ثلاثي فيينا (كليمت وشيلي وكوكوشكا) يرسمها، أمعنت في إعطاء ذلك الكشف العنيف طابعه البصري… وليس فقط عبر الموضوعات المرسومة. بل يمكن القول بأن الموضوعات كانت آنذاك، أضأل ما ينبغي الاحتفاء به… لأن لعبة الكشف تقوم في مكان آخر: في ذلك التزيين والتخطيط المبالغ فيه. في ذلك الكمون الغامض للموت في ثنايا الوجوه التي تحاول الابتسام (شيلي) الموت عبر العري وانحناءات الأجساد وكأنها تلقت الطعنة النهائية (شيلي كذلك)، والموت عبر العيون الشاخصة في تحدٍّ نحو رائي اللوحة (كليمت)، أو ذلك السواد العنيف وخطوط الزاوية التي تميز حركة الشخصيات والأشياء (كوكوشكا). إنه الموت العادي، للوهلة الأولى، في فيينا العادية جداً: فيينا القطار الكهربائي ومقاهي الرصيف وفالسات آل شتراوس، والبدايات الخجولة للحس التعبيري في سينما تعيش أولى ولاداتها، وفي مسرح يعيش أواخر أيامه الذهبية. والموت العادي وقد صار جزءاً من الجنس العادي في كتابات فرويد وتفسيره للأحلام وفي كتاباته عن هاملت وعن قلق الحضارة، وعن الجنس والموت. الموت العادي يغمر كل شيء، ويرتاح في النظرات. هذا الموت نفسه هو الذي نراه كامناً في تحركات شخصيات قصص شنيتزلر وهرمان بروخ. وإذا كان الموت يكمن خلف لوحات ثلاثي فيينا وفي ثنايا هواجس فرويد وأعماله، وفي نهايات بعض أفضل الأعمال الأدبية التي خلفها لنا ذلك العصر، فإن انحطاطاً يشبه الموت وينافسه في عنفه وقتله، سيلوح لمن ينظر إلى نهايات روايات وقصص ستيفن تسفايغ.
المجتمع وحركة الفن
في كل حديث عن فيينا، يجد المرء نفسه أمام عالم كامل: بدءاً بالمفروشات المنزلية إلى ستائر النوافذ، إلى السيارات الأولى إلى الأشرطة التي تحكي لنا المدينة وحياتها العادية في تلك الأثناء، إلى اللوحات الفنية فنماذج المخطوطات والكتب والمجلات. ولعل الملاحظة الأولى التي يستخلصها المرء من هذه الجولة البانورامية التي سيكون قدرها أن تعيش متجمعة إلى الأبد بين دفتي “الكاتالوغ” الذي نتحدث عنه، تكمن في ذلك الالتحام الذي يربط بين مختلف أشياء فيينا: فهنا أمامنا أشياء ومنتوجات تبدو متلازمة مع بعضها البعض، ولا يبدو أي منها وليد صدفة من الصدف، تبدو وكأنها تنويعات على عالم واحد، عالم يعيش انطلاقاً من نظرة أحادية إلى العالم… نظرة لا ترى من العالم، كما أسلفنا، سوى نهاياته. فحركة المجتمع التي تولد عادة عن تركيب معقد بين العديد من العناصر السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية تحدث في لحظات الانعطاف الحضارية نوعاً من الرؤية العامة الواحدة التي تحكم إنتاج الأذهان انطلاقاً من قلق ما أو خوف معين، وهذه الرؤية الواحدة هي التي تفعل في حركة الفن محددة لها، ليس الموضوعات وحسب، بل والأشكال الفنية حتى. ونحن إذا حاولنا أن ننقب في تاريخ مسيرة الفن في تاريخ العالم، سنجد مراحل أو حقباً معينة تكاد هذه النظرة تبدو فيها بشكل شديد الوضوح، مقابل مراحل أو حقب تحتاج النظرة فيها -كي تظهر- إلى تحولات تستديم على مدى عشرات السنين لا أقل. وهذا التسريع أو التبطيء ينبع عادة من كون الحقبة نفسها حقبة انعطاف سريع أو تطور بطيء.
اختراع ما هو أخطر!
وتسارعها في فيينا ينبع من طبيعة المرحلة نفسها: فالاختراعات كانت تتوالى في العالم، والسوق الرأسمالية تبحث عن آفاق لها، والأحداث السياسية تتسارع. كان كل ذلك ينذر باقتراب العاصفة. فهل كانت العاصفة هي مقتل الأرشيدوق النمساوي الذي أعلن اندلاع الحرب العالمية الأولى؟ إن من يستعرض تاريخ فيينا سيصاب بالدهشة إذ يكتشف أن ما يقوله لنا “حلم فيينا” الأخير يأتي معاكساً لهذه القناعة: الحرب الأولى كانت مؤشراً فقط على موت عصر كامل. أما المؤشر على بداية العصر الآخر، فكانت في قلب تلك المدينة (عاصمة أوروبا الوسطى)، ففي موتها الحتمي كانت فيينا، كما في لوحة “الولادة” لغوستاف كليمت، تلد العصر الجديد: مولوداً مشوهاً؟ ربما… لكن المسألة ليست هنا. المسألة هي أن فيينا في موتها اخترعت القرن العشرين كله… بروائعه وانحطاطه، بطابعه اللا إنساني وبعواطفه الجامحة. فيينا اخترعت الفن الذي لا يزال حتى الآن فن القهر الإنساني، وفن اليأس والشر، فن الموت والكابوس السعيد. لكن فيينا “اخترعت” كذلك في ذلك الحين بالذات، ما هو أبعد من ذلك كله وأخطر، اخترعت ذلك الوحش الذي سيكون أسوأ ما يؤثر سلباً في مسيرة الإنسان في القرن العشرين: ففي فيينا نفسها كان يولد وينمو في تلك الآونة بالذات، أدولف هتلر، وتولد معه نازيته التي كادت تدمر نصف حضارة العالم. ترى أفلا يمكننا أن نفترض بالتالي أن فيينا اخترعت حقاً حتى كل ما هو سيئ في القرن العشرين وما سيليه أيضاً؟